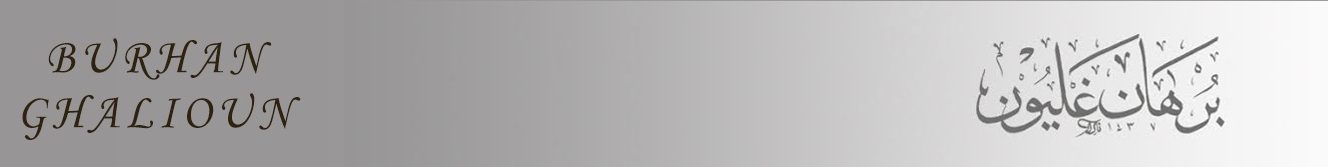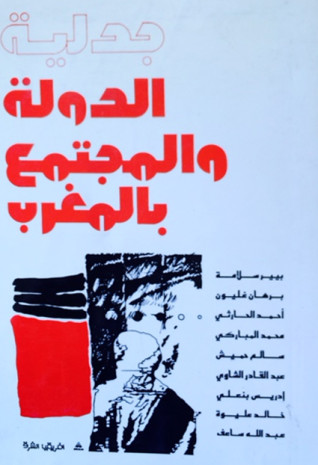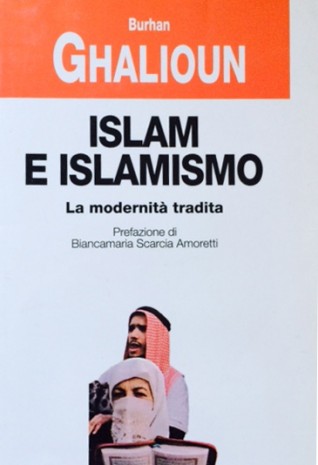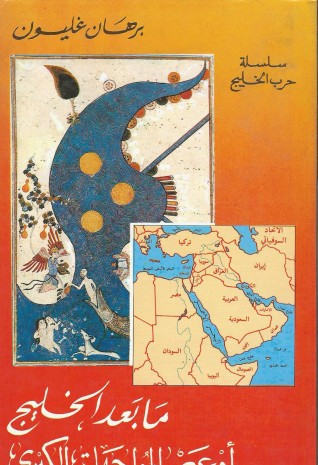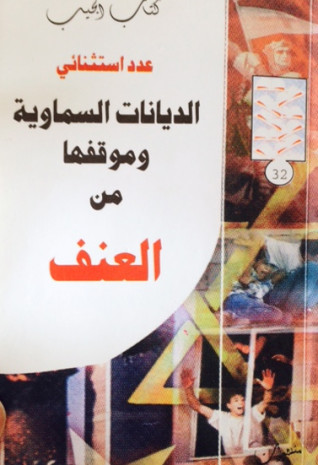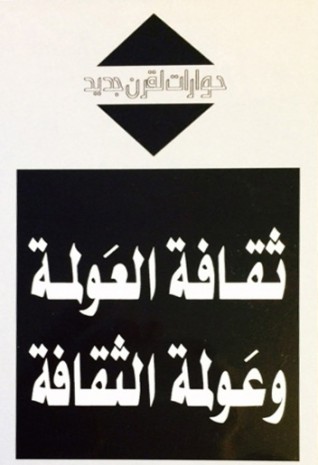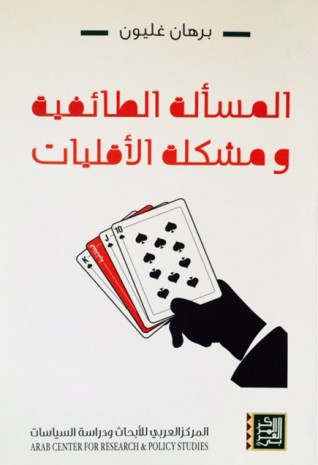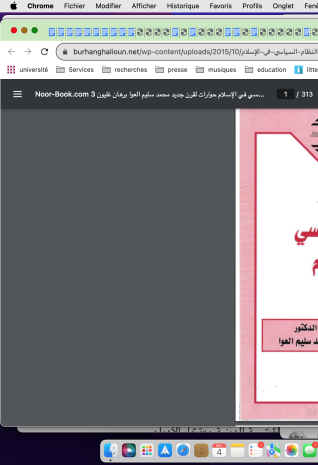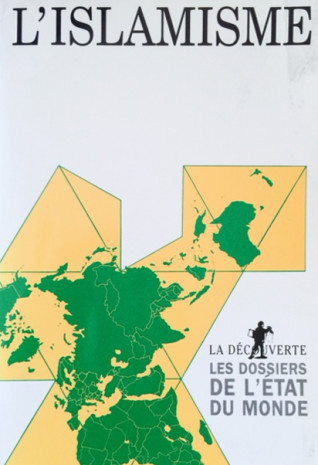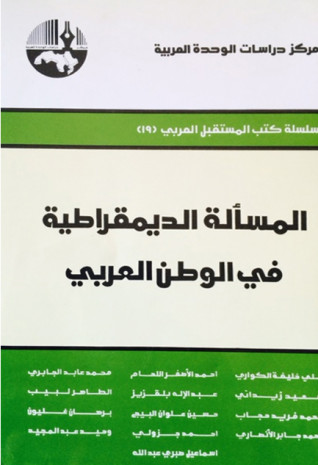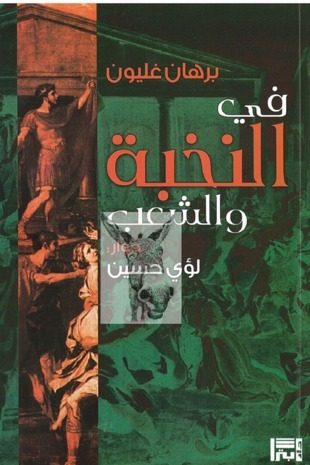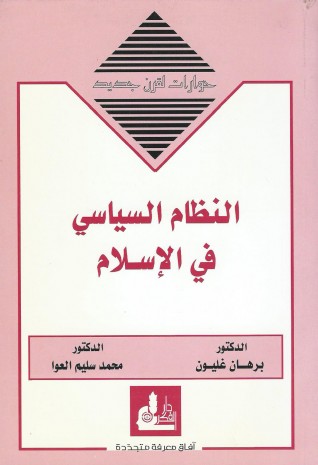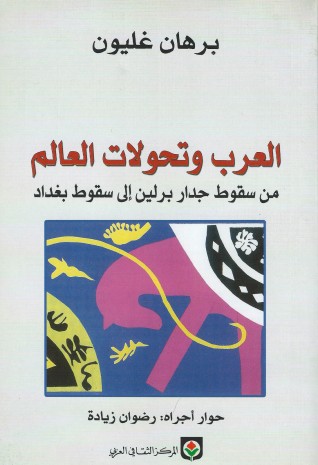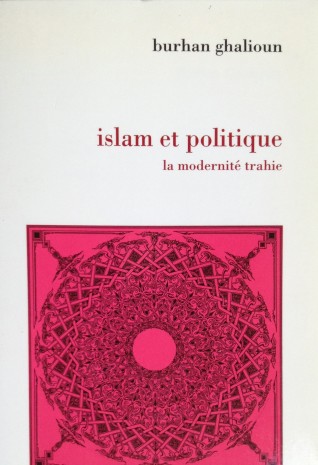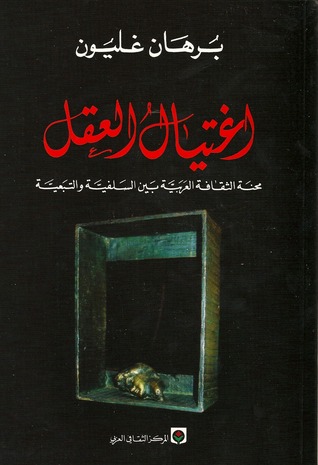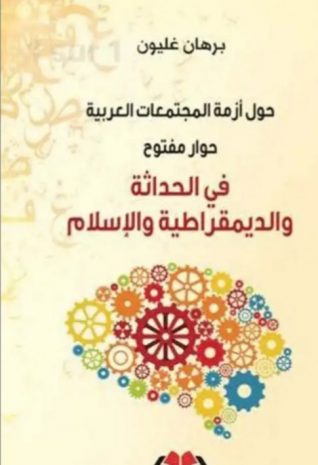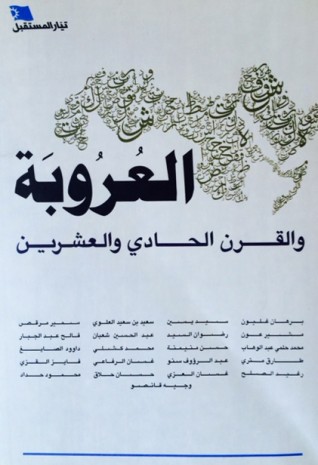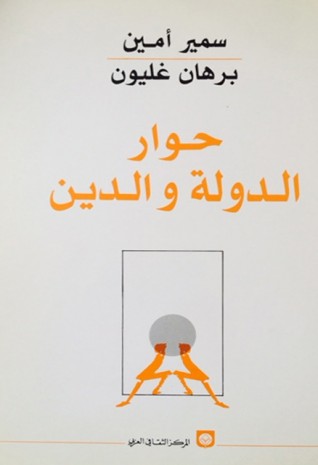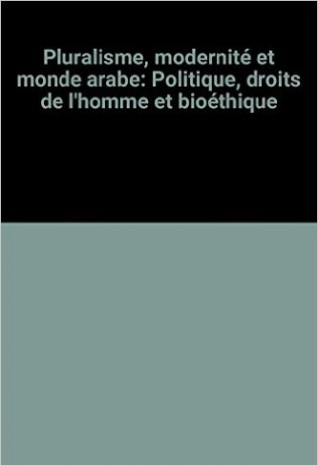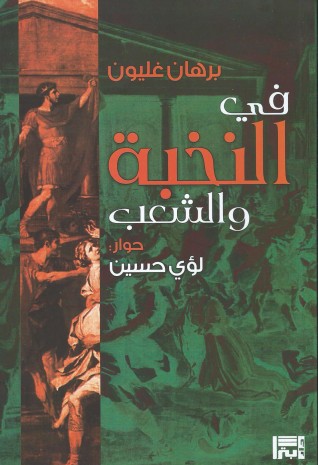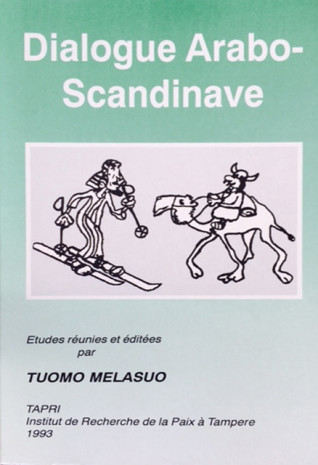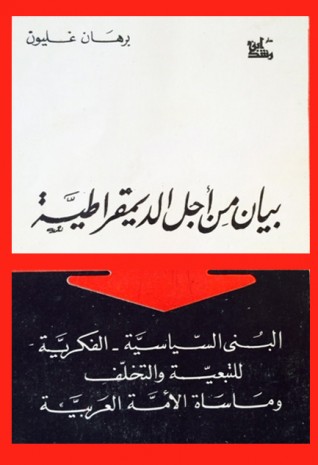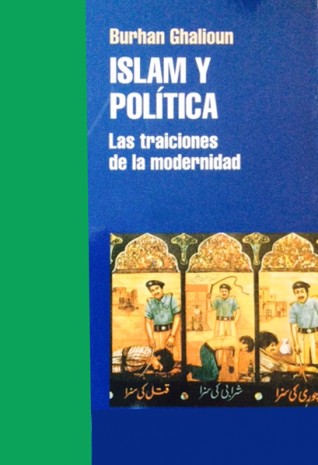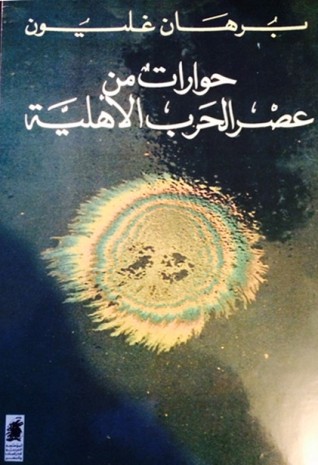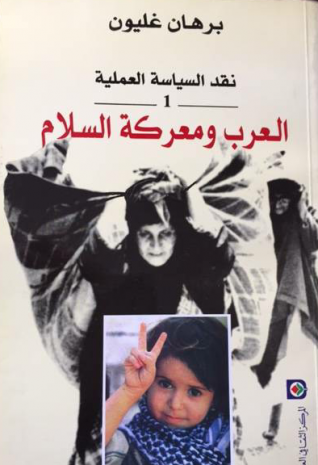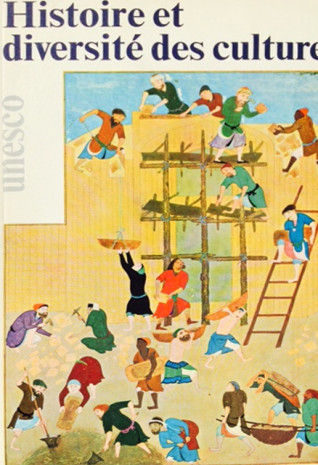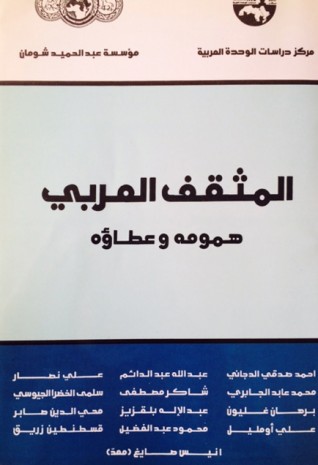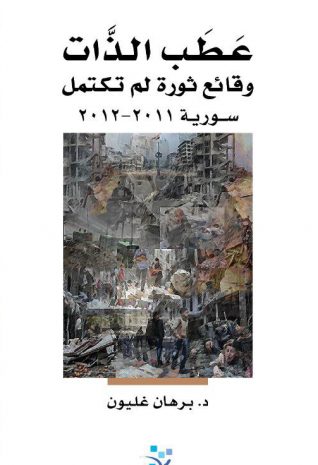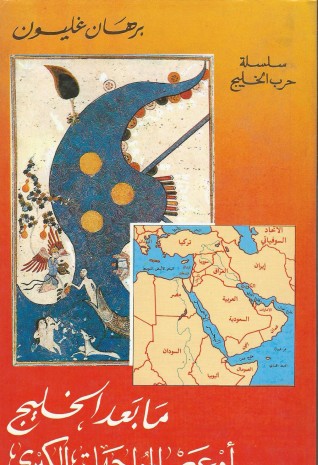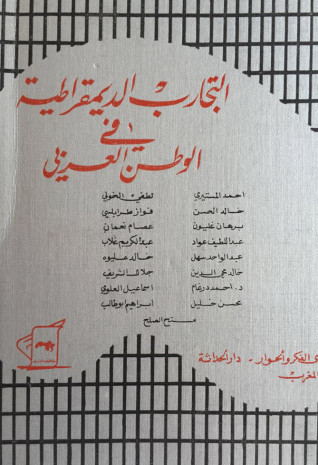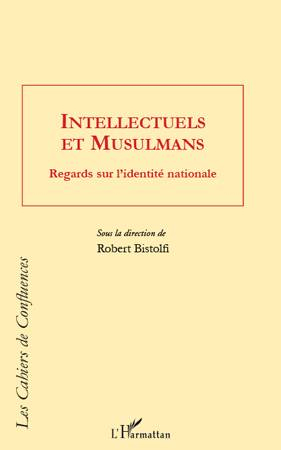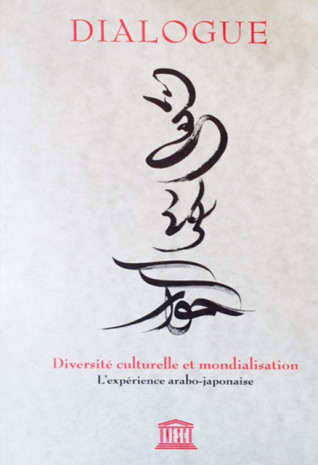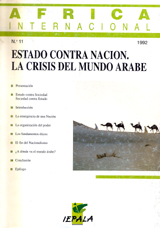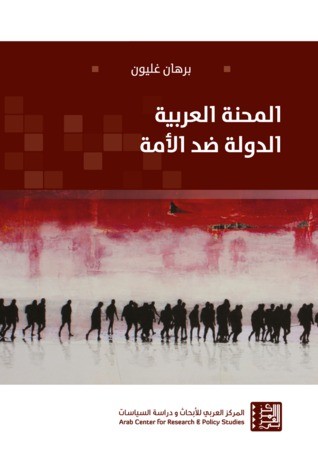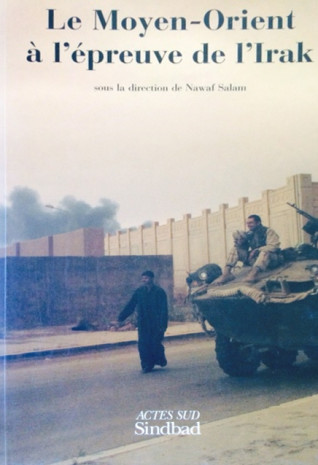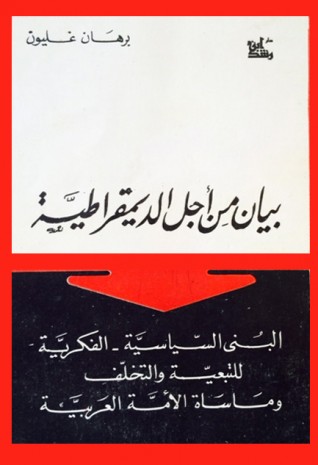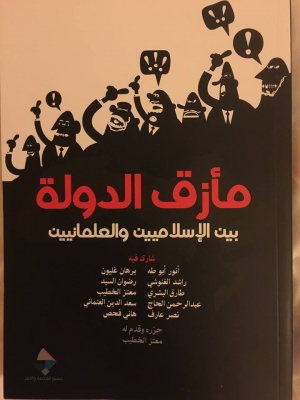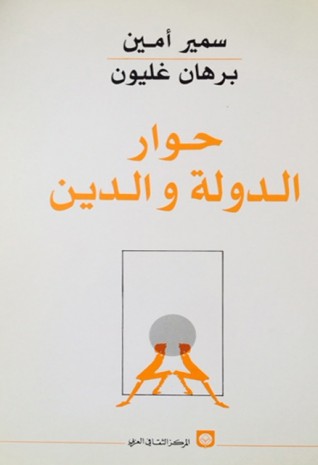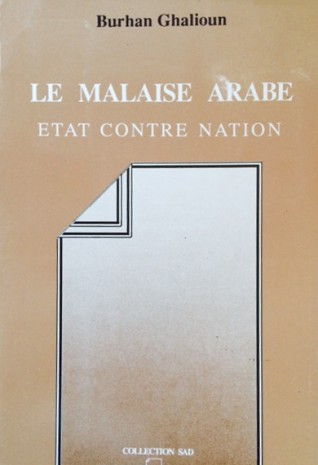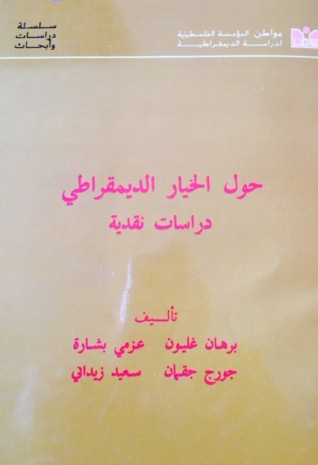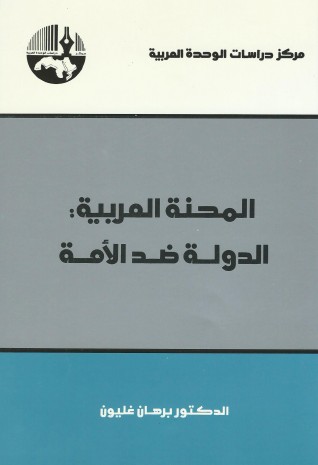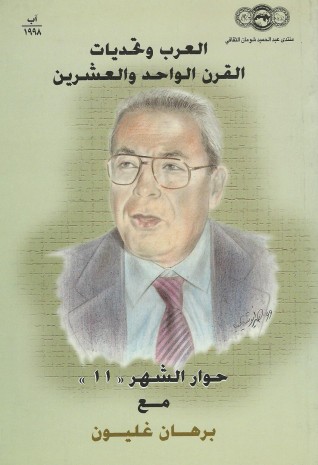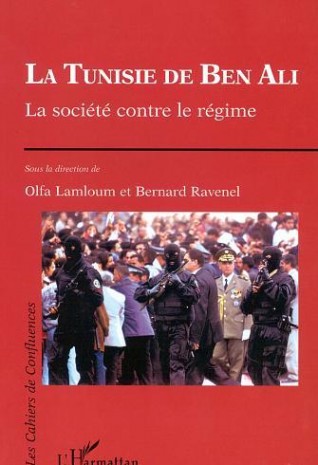مقابلة الحياة: ما الذي يعيق ترجمة أفكار المثقفين العرب إلى برامج عملية؟
2016-02-15 :: الحياة
الحياة _ عمر كايد
* لعب برهان غليون دورا مهما في المجلس الوطني، فهل لعب أدوارا أخرى، في نصرة الثورة، ما هي؟ وهل تراها كافية؟ وما هي الأدوار التي لعبها المفكر برهان غليون في التحولات الأخرى التي عصفت بليبيا ومصر وتونس واليمن والعراق؟
* في معظم الأسئلة يبدو انك تحاول ان تستغني بشهادات الأشخاص المستجوبين عن البحث الجدي والموثق في أدوارهم ومساهماتهم. لايمكن اولا ان تطلب من شخص ان يقيم نفسه الا اذا كان هدفك دراسة صدقه من كذبه. وإلا فإن الدراسة الموضوعية لادوار الفاعلين وسلوكهم وخططهم، بصرف النظر عن تصوراتهم الذاتية، تشكل الجهد الأساسي في البحث الذي يتوجب على الباحث القيام به والذي يظهر قدرته على البحث العلمي والموضوعي ام لا. ما يمكن ان توجهه من أسئلة للأشخاص هو من النوع الذي يساعدك على فهم معنى نشاطهم وحوافزهم ودوافعهم لا وصف ما فعلوا. وأشك في ان وراء أسئلتك اشكالية واضحة ومبلورة للبحث في موضوع مهم وصعب معا هو موضوع المثقف العربي والسياسة. ربما يحتاج منك الامر الى مزيد من البحث النظري والتفكير والإنضاج لما تريد اثباته من فرضيات وماهي الأسئلة الضرورية وذات القيمة التي تطرح بهذا الخصوص.
* طالبت كثيرا بضرورة اجتماع المثقفين العرب والحوار فيما بينهم للتوصل لمشروع مشترك. فما الذي يمنع من اجتماع المثقفين، وهل لعب برهان غليون دورا في جمع المثقفين العرب وكيف؟
* انا لم أطالب ابدا المثقفين بالاجتماع والحوار. الحوار هو موضوع أساسي في الحياة الفكرية حتى لو لم يجتمعوا معا وحتى لو لم يكونوا مثقفين. انا عبرت عن موقفي ورأيي في دور المثقف ومسؤوليته في مجتمع متحول يعيش أزمة تاريخية، وانتقدت من يبني جدارا فاصلا بين الثقافة والعمل العام او الموقف السياسي والاجتماعي ويحيل معنى الثقافة إلى معنى الاختصاص، الأدبي او الفني او الفلسفي او العلمي، ويدعو للانكفاء عليه وعدم الاهتمام بما عداه، وينظر بالتالي إلى السياسة كما لو كانت مهنة خاصة كالمهن الأخرى. في نظري السياسة نشاط عام وجامع وأكاد أقول فرض عين على كل مواطن راشد، وكون الانسان مفكرا او عالما او فنانا لا يمكن أن يعفيه من القيام بواجباته العمومية مثل اي مواطن اخر ولا أن يبرر تخليه عن التزاماته الاخلاقية والسياسية. لا أستطيع ان أتصور مثقف يقول مثلا انه لا شأن له ولا موقف في موضوع الحريات والديكتاتورية والقهر والموت تحت التعذيب في سجون الطغيان الذي يتعرض له هذا الشعب او ذلك، وان مهمته تقتصر على الإبداع في ميدانه الثقافي والعلمي. بالعكس اعتقد ان مسؤوليات المثقفين اكبر بكثير من مسؤوليلت العمال والفلاحين والموظفين الذين يعيشون تحت ثقل ضغوط اجتماعية واقتصادية ونفسية اقوى بكثير. لا شيء يبرر للمثقف هربه او تهربه من مسؤولية الدفاع عن القيم والمبادىء والمعايير الاخلاقية والسياسية الانسانية.
خارج هذه الاعتبارات لا يمكن جمع المثقفين فهم ليسوا طبقة ولا نخبة مستقلة وقائمة بذاتها. منهم اليساري واليميني والإسلامي والعلماني والفقير والغني وابن الريف وابن المدينة. وقد ينتمون الى احزاب مختلفة ويتطلعون الى لعب ادوار متنوعة. توحيدهم وتجميعهم ليسا هدفا. الهدف هو إجماعهم على رؤية مرجعية اخلاقية وسياسية مشتركة او تنمية ضمير ثقافي وفكري موجه مشترك لأكثرهم، في ما وراء الاختلاف السياسي والأيديولوجي. وهذا ما لم ننجح فيه بعد.
* هل قدم برهان غليون بطروحاته ما يحصن الشباب من الالتحاق بالجماعات المتطرفة؟ أولا كيف يمكن تحصين الشباب؟ وثانيا كيف قمت بذلك؟
* روى لي صديق كان بسبب مهنته قريبا من الأوساط الرسمية الحاكمة في سورية. وكان له ولد يدرس في الخارج وفي كل مرة يعود فيها الابن الى سورية للزيارة يوقف من قبل المخابرات في المطار ويحقق معه ساعات وأحيان ينقل إلى النظارة. وعندما كان والده يتدخل لدى المسؤولين من معارفه محتجا بأن هذا ابنه وانه لا يمكن ان يعامل هكذا ولا ان يشكك فيه كان يسمع من الأمن الجواب نفسه: نحن نعرف أنه ابنك وأنه لم يرتكب خطأ، لكن الهدف هو تحصينه حتى لا يخطيء في المستقبل. وهذا ما نفعله مع جميع الشباب.
المثقف، مفكرا كان أم فنانا أم عالما، لا يستطيع أن يحصن أحدا. فهو ليس مربيا ولا يستطيع ان يحل محل المربين. والتربية في بلداننا ليست في يد المثقفين ولا حتى المربين وإنما هي تربية عملية تشبه تدجين الحيوانات المتوحشة وتقوم على التهديد والترويع والضغط والابتزاز من قبل القوى الرئيسية المتحكمة بسلوك الأفراد والجماعات، وهي قوى مزدوجة، أمنية ومخابراتية مرتبطة بالسلطة السياسية الديكتاتورية ودينية تتجسد في أغلب رجال الدين الذين يوجهون الأفراد من خلال الوعد والوعيد والترويع من العقاب الإلهي. ولا يمكن للمثقفين مهما بلغت شهرتهم وقوة أفكارهم أن يقاوموا عمليات الترويض الجماعية والهائلة التي يشترك فيها رجال السلطة ورجال الدين معا، ويضاف إليها برامج التواصل الاجتماعي والإعلام الداخلي والدولي الذي يستحوذ على انتباه الاطفال والشباب، خاصة وأن نسبة القراءة والقارئين في العالم العربي هي من أدنى نسب القراءة في العالم قاطبة. ثم إن التحاق العديد من الشباب بالحركات المتطرفة أو تطرفهم الفكري لا ينجم عن تقصير في التربية والثقافة، ولكنه يشكل رد فعل آلي تقريبا، في كل مكان في العالم، على الاحباط واليأس وفقدان الأمل في الاصلاح وفي المستقبل، وهو رد فعل من طبيعة الفعل الذي يخضع له أغلب الشباب في مجتمعات الفقر والبؤس والاقصاء والذي يجعل الموت أكثر انتاجا للمعنى ومصدرا للشعور بالكرامة واحترام الذات في مواجهة حياة الذل والعبودية وانعدام الأمل. وفي جميع الاحوال، ليس الفكر المتطرف هو الذي يخلق التطرف أو يدفع إلى السلوك المتطرف. العكس هو الصحيح. إن إن روح التطرف المتفجرة عند الشباب المهدور الحقوق هي التي تستدعي انتاج الفكر المتطرف، وتدفع إلى إعادة تفسير أفكار تسامحية على شكل رديكالي يبرر القتل والتطرف، بصرف النظر عن مصدرها الديني أو الدنيوي. وكما أن العمل الاجرامي لا يحتاج إلى عقيدة ولا نظرية ولا فكر، كذلك لا يحتاج التمرد إلى عقيده تدعو له، ولكنه هو الذي ينتج عقيدته بنفسه عندما يصبح حقيقة واقعة لا مفر منه. تحصين الشباب ضد التطرف يحتاج إلى إلغاء الشروط التي تدفع إلى التمرد، وإلى العمل الجماعي، الذي ينبغي على المثقفين المساهمة فيه، من أجل وضع حد لسياسات القهر والإذلال والاحباط واليأس التي تغذي في كل مجتمع ومنطقة ارادة الثار والانتقام لدى الأفراد. من دون الاعتراف بوجود الناس وبحقوقهم واحترام عقولهم وسيادتهم وحرياتهم ليس هناك اي وسيلة للتحصين ضد التطرف. وليس لأي فكر مهما كان مبدعا وقويا أن يقف، بممارسة مثل هذه السياسات، أمام روح التمرد والانتقام التي تستعر في النفوس.
* خرجت من المجلس الوطني لأمور كثيرة تحدثت عنها في مقابلاتك، الأمر الذي دفعك لتنكفأ عن العمل السياسي وتعود مجددا إلى العمل الأكاديمي... فهل هذه العقبات التي واجهتها على الصعيد العملي، يمكن أن تحل بالكتابات؟ أليست الكتابة ترف وغير واقعية. وتجربة المجلس الوطني نموذجا. أليست الأموال والاصطفافات والدعم الخارجي هو مصدر القوة وهو الذي يغير بالتوازنات ويصنع التاريخ، وليس الكتب والنظريات حتى لو كانت محقة. فنحن في عصر القوة؟ كيف يمكن للمثقف أن يكسر من هذه المعادلات أو يغيرها.
* أنا لم أترك العمل السياسي وانكفء على العمل الاكاديمي كما تعتقد، لأن مشاركتي في الثورة لم تكن خروجا عن مساري الأكاديمي، وإنما تلبية لواجباتي كمواطن حر. بمعنى آخر دخولي في النشاط السياسي لم يكن من قبيل الاحتراف للسياسة وإنما المشاركة في ثورة شعب قرر انتزاع حريته وحقوقه، شارك فيها مثقفون وغير مثقفين وعمال وفلاحون وحرفيون وباطلون عن العمل. وجميعهم لم يحترفوا السياسة ولن يحترفونها. ولا يختلف وضعي عن وضعهم. في لحظة حاسمة كالثورة التي يتقرر فيها مصير مجتمع كامل لعقود طويلة، لا يعود للاحتراف السياسي وغير السياسي معنى، ويلتقي بالضرورة أناس من كل الاتجاهات والحرف والمهن الفكرية وغير الفكرية. وليس هناك تناقض في أن يكون المرء أكاديميا وناشطا سياسيا أيضا في ثورة كبرى، تماما كما أنه لا تناقض بين أن يكون المرء مدرسا وثائرا، أو فلاحا وثائرا. ما تغير خلال رئاستي للمجلس الوطني هو أنني كرست وقتا اكبر، وربما الوقت كله، للمهام السياسية، والأفضل تسميتها المهام الثورية، لأن الثورة ليست من مهام السياسة العادية والطبيعية، وإنما هي رد فعل على عطب السياسة وشللها.
وليس هناك معنى عندي لفصل العمل النظري الأكاديمي والفكري عموما عن الممارسة السياسية، بمعنى قيام المثقف بواجباته الوطنية والوفاء بالتزاماته تجاه مجتمعه كأي مواطن آخر. لكن هذه الواجبات ليست دائما نفسها ولا من طبيعة واحدة. وأحيانا يكون للمساهمة النظرية دور أساسي في تقويم الممارسة السياسية، وأحيانا يتخذ العمل التنظيمي السياسي أو العسكري قيمة رئيسية. وعلى جميع الاحوال ليس صحيح أن "الكتابة ترف وغير واقعية" وأن "الأموال والاصطفافات والدعم الخارجي هو مصدر القوة وهو الذي يغير التوازنات ويصنع التاريخ". مصدر القوة الرئيسي يكمن في تصميم الشعوب ووحدتها وإرادة التحرر والانعتاق فيها. وليس المثقف ساحرا حتى يكسر المعادلات ويغير التوازنات بفكره ويلغي الواقع وتوازناته والفاعلين الآخرين. الفكر الذي يميز المثقف هو عنصر من ضمن عناصر لا تحصى تساهم في تكوين توازنات مركبة، سياسية وجيوسياسية وعسكرية. وليس لدى المثقف ولا السياسي ولا العسكري عصا سحرية حتى يتحكم بهذه التوازنات، ولا توجد أصلا عصا سحرية عند أحد. التاريخ يولد من تفاعل العناصر والقوى وصراعها. وأي فرد لا قيمة له إلا في سياق عمل القوى والجماعات ومن خلالها.
* هل تفرق بين مفهوم المثقف أو المفكر أو النخبة.
* المثقف اسم عام يشمل مفكرين وغير مفكرين وأعضاء في مهن غير فكرية يشغلهم الهم العام ولهم اهتمام بشؤونه. أما النخبة فهي مفهوم اجتماعي يشير إلى فئة من المجتمع موحدة التوجهات الفكرية والسياسية، لها وظيفة في الهيكلة الاجتماعية. فالنخبة المثقفة تشير إلى ما يسمى في الأدبيات السياسية العالمية بالانتلجنسيا التي تقوم بدور موحد ومنسق ومعبء للأفراد في سياق تحولات ثورية أو إصلاحية. وهي تختلف عن النخب الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها.
* نرى أن المثقفين عادة يكتبون عن مفاهيم ونظريات. ألا تعتقد أن من مهمة المثقف أيضا تقديم برامج عملية.
* ليس من واجب كل مثقف أن يقدم برامج وخطط عملية، وأن يعمل كقائد سياسي. ولا يستطيع كل مثقف أن يمتلك القدرة على بلورة برامج سياسية عملية حتى لو كان واسع الاطلاع. هناك مثقفون يملكون امكانية التفكير العملي واخرون أكثر ابداعا في مسائل التفكير النظري التاملي، حتى لو كان انخراطهم قويا في النشاطات السياسية والاجتماعية.
* ما الذي يعيق ترجمة أفكار المثقفين العرب إلى برامج عملية؟ هل فقط مهمة المثقف تقديم النظريات أم مهمته أيضا الانخراط في التغيير وتقديم برامج عملية تطبيقية؟
*ليس للبرامج العملية علاقة بالثقافة أو بالمثقف. البرامج العملية جزء من ممارسة عملية لا تكون ولا تستقيم إلا بوجود فاعل جمعي، أي قوة سياسية أو اجتماعية منظمة وواعية لديها مشروع وهدف تعمل من أجله. البرامج العملية ليست مسألة تأملية وفكرية.
* هل تتواصل مع الجمهور وكيف؟
* نحن نعيش في عصر التواصل الاجتماعي المتعدد الوسائل واللغات والاهداف. السؤال الأصح هو هل يستطيع مثقف منخرط اليوم في الشأن العام أن يهرب من التواصل مع الجمهور أو الحوار معه؟ والسؤال أيضا : أي جمهور؟ فالجمهور ليس واحدا وإنما هو جماهير، جمهور الكتاب والمثقفين وجمهور السياسة والأعضاء الحزبيين، وجمهور الشباب والناشطين وجمهور المواطنين العاديين.
* برأيك هل من الخطأ انخراط المثقف (طبعا نتحدث عن المثقف الكبير صاحب النظريات الكبرى وليس عن المثقفين العاديين) بأحزاب؟ وما هي المعايير التي ينبغي أن تحكمه إن انخرط بها؟
* هذه مسألة اختيار شخصي محض. يمكن للمثقف أن ينخرط في حزب ويمكن أن لا ينخرط ويلعب دورا سياسيا إذا أراد. ولا يقلل الانخراط في حزب من استقلال فكر المثقف ونقديته إذا لم يكن الحزب الذي ينتمي إليه حزبا عنصريا أو عقائديا. ومعظم الأحزاب في البلدان النامية قامت على كاهل مثقفين. المثقفون ليسوا قبيلة أو عشيرة أو طائفة واحدة يتماهى فيها كل فرد مع الآخر ويذوب في العصبية الجامعة. بالعكس، فردية المثقف وفرادة فكره هي جزء من كيانه. وهي تفسر أيضا نزوع المثقف عموما إلى الاحتفاظ بحريته واستقلاله.
* نحن في عصر التكنولوجيا الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. كيف استفاد برهان غليون من هذه المواقع لنشر فكره وطروحاته؟
* لدي بلوغر وصفحة فيسبوك وتويتر، وسأطلق قريبا موقع رسمي يضم عددا كبيرا من الكتب والدراسات والمقالات التي نشرتها خلال السنين الماضية باللغات المختلفة.